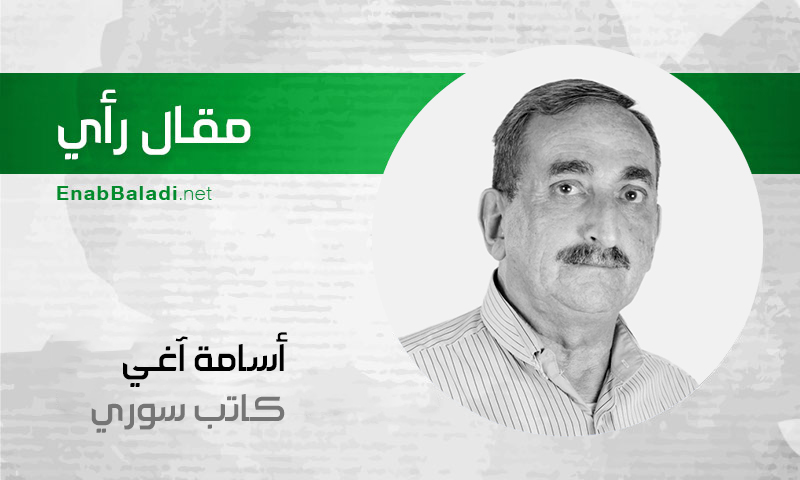جدليّة العلاقة بين اللامركزية والمرحلة الانتقالية

عبدالله الخير
يرخي الاختلاف الذاتي والموضوعي بين مفهومي اللامركزية والمرحلة الانتقالية ثقله عند معالجة التداخل بين المفهومين والأثر المتبادل لكل منهما على مسار الآخر.
فاللامركزية في جوهرها طموح وآفاق، في حين أن المرحلة الانتقالية تمثل جملة تحديات ورهانات مركبة ومتعددة.
بعبارة أوضح؛ المرحلة الانتقالية هي المحطة الأدق عبر سيرورة الإدارة المحلية، واللامركزية تقوم من هذه المرحلة بمقام المنارة التي ترشد وترشِّد السلوكيات السياسية للأفراد والجماعات والقوى، مع ما تحمله من معاناة وطموحات.
مقتضى ذلك أن اللامركزية هي الأداة الأهم في معالجة رهانات المرحلة الانتقالية، وحتى يظهر أثر هذه الأداة لا بد من تدقيقها وتحديدها، ثم وضع الأطر المناسبة التي تتحرك اللامركزية من خلالها.
وفي هذا السياق لا بد من صياغة أفكارنا بتساؤلات، نحاول في عجالة الإضاءة على ما تنطوي عليه من أفكار:
لماذا اللامركزية؟ ماذا نريد منها؟ ما انعكاسات الموضوعية للمرحلة الانتقالية على اللامركزية؟ هل يمكن أن تصيب تحديات المرحلةِ الانتقاليةِ اللامركزيةَ بانحرافٍ على مستوى المطالب والطموحات؟ وكيف تؤدي اللامركزية دور العاصم من هذه الانحرافات؟.
البعد “الإداري” تحديدًا
إذا كنا نتساءل لماذا اللامركزية، تسعفنا الواقعة «الإدارية» المحلية الحالية والتاريخية بالإجابة بأن التهميش الذي كان يعاني منه سكان الوحدات المحلية، على اختلاف مستوياته، الإدارية والأمنية والخدمية، حفَّز تطلعاتهم نحو تحسين جودة إدارتهم المحلية. وطالما أننا حددنا منطلقنا نحو اللامركزية، والمتمثل في تحسين جودة الإدارة المحلية، فإننا نريد من اللامركزية تحسين الواقع الإداري تحديداً، ما يعني توزيع الوظيفة «الإدارية» بين السلطة المركزية والهيئات المحلية، بما يحقق الإدارة الرشيدة للوحدات المحلية.
وهنا يغدو التساؤل عن معيار التوزيع الوظيفي الإداري مشروعاً، وتكون الإجابة الكلاسيكية، ربما، أن توزيع الوظيفة الإدارية بين المركزية والهيئات المحلية معناه الاعتراف بوجود هيئات محلية تمارس إدارة متميزة عن إدارة السلطة المركزية، ما يلزم منه الإقرار بوجود مصالح إدارية وخدمية ومرفقية محلية متميزة عن المصالح الإدارية والخدمية والمرفقية المركزية، وبالتالي تصبح مسألة التمييز واضحة، فما هو مصلحة إدارية خدمية محلية تنهض به الهيئات المحلية، وما هو مصلحة إدارية وطنية خدمية استراتيجية كلية ينعقد به اختصاص المركزية، ونكون أمام لامركزية إدارية، يتبلور لدينا أن ما نريده من اللامركزية بعدها الإداري تحديداً.
مخاطر الخوض في البعد السياسي
إلاّ أن الأمر لا يجري عادة بهذا الوضوح عموماً، وخصوصاً في المرحلة الانتقالية، فهذه المرحلة -كما قدمنا- مركبة من جملة رهانات وتحديات، يبدو بصورة واضحة أنّها تحمل تناقضات المرحلتين المؤقتة والمستقبلية.
المرحلة المؤقتة قد تحمل في رحمها أفكاراً تقدمها على أنها حلول لمشاكل المرحلة السابقة؛ وفي هذه النقطة تحديداً قد يغدو معقولاً التخوف من اللامركزية على أساس أنها قد تحفز نزعات انفصالية، أو نزعة نحو اللامركزية السياسية.
ويبدو أن حالة التهميش التي عانت منها الوحدات المحلية في مرحلة سابقة تخلق لديها حالة من «التشوّق» نحو التغيير والانتقال والمشاركة في إدارة شؤونها، فتبلور طموحها -وهي في الحالة الحماسية تلك- في إطار اللامركزية السياسية، ظناً منها أنها مخرجٌ لما عانته في مرحلة سابقة من الواقعة الإدارية المحلية.
وأمام هذا المشهد، وكردة فعل لدى النزعة المركزية، تتعالى أصوات من هنا وهناك لمقاومة اللامركزية إجمالاً، والدعوة إلى التحصّن بالمركزية كضامن لوحدة البلاد.
ونكون أمام حالة «وهمية» من قبل الطرفين، فلا اللامركزية السياسية هي المخرج من معاناة الطرف الأول، ولا المركزية هي عامل الاطمئنان لدى الطرف الثاني.
وتخريج هذه الحالة الوهمية أن المحليات قد لا تدرك أن سبيلها لتحقيق المشاركة الفعلية في إدارة وحداتها المحلية يكمن بوضوح في توزيع الوظيفة الإدارية ببعديها الإداري والمرفقي، وعلى المستوى التنموي أيضاً، وأن اللامركزية السياسية بما تعنيه من توزيع الوظيفة السياسية بأبعادها (التشريعية، القضائية، التنفيذية)، ليست هي الكفيلة دوماً بتحقيق طموحاتها، وأن الفيدرالية لا تولد بقرار، وإنما هي خصوصيات لمسارات تاريخية معينة، وهي حلول لإشكاليات سياسية بالأساس، رافقت تكوين وتشكيل وتطور الدولة كفكرة ومؤسسة.
وبالتالي كلما كانت فكرة أن طبيعة الموضوعات التي تتصدى لها الوحدات المحلية، إداريةٌ ومرفقيةٌ محلية، وليست ذات طبيعة سياسية كلية، واضحةً، كلما قللت من القلق من النزعة الانفصالية.
ولا بد من إيجاد مقاربة بين الطموحات التي تفرزها المرحلة الانتقالية لدى الوحدات المحلية وبين اللامركزية الإدارية تحديداً، كمطلب تنموي وطني كلّي، وأنشودة يرنو إليها الأفراد والجماعات والقوى.
اللامركزية الإدارية و “الحكم الرشيد”
اللامركزية الإدارية ليست إلاّ مجرد عنوان عام لبُعدٍ إداري آخر يكاد يكون مؤشرها ومعيارها، وهذا المعيار ضارب جذوره التاريخية منذ الإغريق، كما أنه يشكل خلاصة التجربة الإنسانية في مجال الحكم السياسي والإداري، ومؤشر في الوقت ذاته على مدى كفاءته، وهو أسلوب الحكم الرشيد، الذي يقوم على مستويات ثلاثة:
1. المشاركة:
وتعني أن يكون لكل الأفراد والجماعات والقوى المحلية دور في صنع القرارات التي تؤثر في محلياتهم، سواء بصورة مباشرة أو عبر مؤسسات أو منظمات وسيطة يجيزها القانون، بهذا المعنى يعتبر مفهوم المشاركة شديد الارتباط بالمجتمع الديمقراطي.
فالحكم الرشيد لا يقوم إلا بالمشاركة، بينما لا تكون المشاركة إلا بوجود المجتمع المدني، وبدورية الانتخابات، وتمكين المرأة، والتشريع والإدارة المحلية.. إلخ.
2. سيادة القانون:
إن وجود القانون العادل وسيادته مقدمة ضرورية لخلق بيئة آمنة ومعروفة مسبقًا لحياة وعمل جميع المواطنين في المحليات. ويفترض بالقانون أن يعلو على الحكم ذاته، وأن يكون معلنًا ومعروفاً، وأن يطبق على الجميع دون تمييز.
ولكي يطبق القانون يتوجب وجود المؤسسات والهيئات المعنية بذلك، ومأسسة أوجه الخدمات والنشاطات التي ينهض بها المجلس المحلي.
3. الشفافية والمساءلة:
الشفافية والمساءلة مفهومان مترابطان، ويشكلان معًا أهم مقومات الحكم الرشيد، وتعني الشفافية التصرف بوضوح وعلانية، والسماح بتدفق المعلومات، بشكلٍ يستطيع معه كل مهتم بموضوع معين أن يجمع المعلومات الضرورية لتحديد سلوكه تجاهه.
وأكثر من ذلك، تتطلب الشفافية تحديد الإجراءات في مجال اتخاذ القرار العام بكل وضوح وعلانية، واعتماد قنوات مفتوحة للاتصال بين أصحاب المصالح والمسؤولين.
أما المساءلة فتعني تحمل مسؤولية اتخاذ القرار والنتائج المترتبة عليه، وإتاحة الفرصة لاستجواب المسؤولين، وتأخذ المساءلة أشكالًا مختلفة، فقد تكون مجرد نقاش واستفسار عن حيثيات اتخاذ قرار ما، أو حصول نتيجة معينة لسلوك معين، لكنها قد تأخذ أشكالاً جزائية وقانونية.
وفي الأنظمة الديمقراطية تشكل دورية الانتخابات نوعًا من المساءلة عن السياسات المطبقة بنجاحاتها أو إخفاقاتها.
وهكذا نرى أنه بقدر وضوح فكرة الحكم الرشيد وآلياته ومعاييره في المرحلة الانتقالية، وقبلها في المرحلة المؤقتة، من خلال ما قد يتاح من إمكانيات لتطبيقه وسط التحديات والعوائق الكثيرة الموجودة فيها، يصير لدينا ممرٌّ آمنٌ للجهاز الإداري للدولة عبر مسار الانتقال من المؤقت إلى الانتقالي إلى المستقبل المستقر وفق التموضع النسبي للحكم الرشيد.
وهو ما يعطي اللامركزية الإدارية زخمها الكفيل بتمحيص مشاكل المرحلة السابقة، والتنقيب عن البدائل والحلول الملائمة والملبية للطموحات، والمنسجمة مع وحدة وتماسك كيان الدولة الإداري والسياسي والاقتصادي.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :