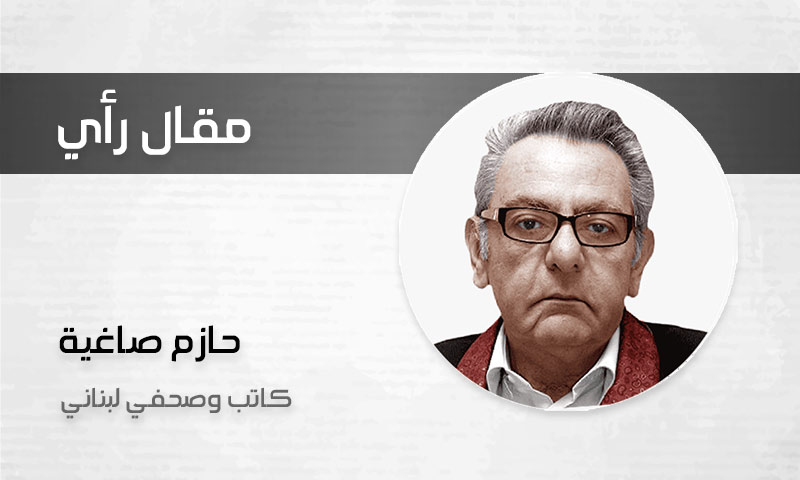ليلةَ الثلاثاء في 14 الجاري، اقْتِيدَ عشراتُ الشبان إلى «ثكنة الحلو» في بيروت، بعدما جرَّبت القوى الأمنية عليهم عنفَها المفرط. هؤلاء تحدَّثوا، إثر خروجهم، عن الضرب والإهانة اللذين تعرضوا لهما؛ لكنَّهم أيضاً نقلوا عبارات «سياسية» قليلة ومقتضبة سمعوها، عبارات تنمُّ عن «ثقافة» الاحتجاز الراهنة في لبنان.
ونعلم أن ما يقوله السجان للسجين كلام «صادق»، بمعنى أنه يعكس بشيء من الدقة ما تنطوي عليه نفس السجان وعقله. ذاك أن هذه العتمة التي تجمع الاثنين، يغيب عنها الرأي العام والإعلام، كما تغيب احتمالات العقاب الذي يُمليه القانون بما يردع الجاني ويحاصر المرتكب. بل تغيب كذلك المعايير المتمدنة التي تنظم العلاقة بين شخصين يُفترض أنهما متساويان. هكذا يُترك للسجان، وهو – تعريفاً – من انفصلت عنه أناه العليا، أن يتفلَّت من الضوابط كلها، وأن يطابق ذاته الطبيعية والأولى.
أبعد من ذلك أن السجان يعامل موقوفه كأنه لا أحد، واللا أحد لا يسمع، وإذا سمع لا ينقل، وإذا نقل ازورَّ عنه السامعون «المحترمون» أو كذَّبوه. وهذا جميعاً يتيح له أن يضرب فيما يظنُّه جثة، فلا يكتفي بالانتقام لدونية عميقة فيه؛ بل ينفِّس مرارات متراكمة كان آخرها جهده العنفي في مواجهة محتجين غاضبين.
باختصار، تتضافر العوامل التي تستدرج ما هو سادي في السجان، وتطلق له العنان.
ولئن كان لفضول التلصص على مونولوغ السجان إغراؤه المؤكد، فإن ما يرويه الخارجون من الاحتجاز يلبي فضولنا قاطعاً الشك باليقين. ومما رواه الشبان هؤلاء تحسر السجانين «لأننا لسنا في سوريا» واشتهاؤهم أن يكونوا هناك. ذاك أن «قلب العروبة النابض» كان ليتيح قدراً من الفتك والأذى بالموقوفين يتردد أمامه «بلد التسويات الطائفية». وهذا الحب الذي يُبديه السجان لـ«سوريا الأسد» بوصفها الحالة المثال، لا يكتمل إلا بحقد على ضحاياها السوريين. فهم – وفق الرواية إياها – يخضعون للضرب والمهانة بما يفوق ما يخضع له رفاقهم اللبنانيون، فضلاً عن احتجازهم في ثكنة الحلو لمُدد زمنية أطول.
هذا التلاقي بين الإعجاب بالأسد والكره للسوريين، يلخص وجهاً أساسياً من وجوه «ثقافة» الزنزانة اللبنانية، وجهاً يستدخل ويستعرض بعض أسوأ ما يعرفه المجتمع اللبناني واجتماعه، جلداً للضحية وتماهياً مع جلادها.
إحدى محطات هذا السلوك نشأت إبان سنوات الوصاية السورية. يومذاك احتضنت بعض الأوساط «نظرية» ضمنية مفادها التالي: «نحن (اللبنانيون) شعب عظيم وحاكم سوريا حافظ الأسد قائد عظيم. إنه يليق بنا، بينما يليق حكامنا العاديون (موظفو الأسد في بيروت) بشعب سوريا العادي».
لقد انطوت تلك «النظرية» على اشتهاء استبدالي: تَذللٌ للغالب تماهياً معه من موقع ذليل، وتشاوفٌ على المغلوب، أي السوريين من شركاء اللبنانيين في الانغلاب أمام الأسد، لإبعاد شبهة التذلل عن أصحابه.
و«النظرية» هذه أحد مصادر «حلف الأقليات» اللاحق: اللبنانيون العظماء انحازوا إلى العظيم ابن العظيم ضد السوريين العاديين الذين تعاطف معهم لبنانيون عاديون. أما مشاركة «حزب الله» في الحرب السورية، فحسَّنت شروط التبعية التي تربط العظيم الأصغر بالعظيم الأكبر. لقد سدَّد الدَّين مصحوباً بفائدة مرتفعة.
لكن استنفار هذا التلاقي بين حب الأسد وكره السوريين في مناخ الثورة اللبنانية وقمعها، فيدلُّ إلى يد قامعة غير منظورة: إنها الثورة المضادة في سوريا الأسد، وفي عموم المنطقة تالياً، وهو ما لا يجوز لثوار لبنان نسيانه أو تجاهله، والظن أن عين الشقيق الأكبر ساهية عنهم.
شيء ثالث ذكره الخارجون من التوقيف، يتمم تلك «الثقافة»، ويلقي مزيداً من الضوء على مخاطرها. فالموقوفون عُيِّروا بأنهم «صهاينة»، تطبيقاً لمبدأ أسدي استوطن لبنان حتى 2005 قبل أن يرثه «حزب الله». ومفاد المبدأ هذا ابتزاز الخصوم والمعارضين بحجة لا تعدو كونها تمريناً لفظياً تلقائياً. فخلف امتهان مَن يُتهم بالصهيونية يقيم امتهان أكبر للتهمة ذاتها. والحال أن هذا البيع والشراء المتواصل في بازار الصراع اللفظي مع إسرائيل، هو «ثقافة» السجن السوري الكبير بقدر ما هو «ثقافة» السجون الصغرى المتفرعة عنه في سوريا وفي لبنان. وهذا ما تتلقفه أصوات لا تُبقي منه إلا العداء الفعلي للفلسطينيين، كأنْ تُخبرنا مثلاً محطة «أو تي في» التلفزيونية العونية أن «فلسطينيين ملثمين بالكوفيات، ويتحدثون باللهجة اللبنانية» شاركوا في تظاهرة بشارع الحمرا.
والآن، مع حكومة اللون الواحد الموعودة، والتي يبدو أنها لن تولد إلا في الدم، يُقدر لهذه «الثقافة» أن تحرز مزيداً من الانتشار والتوسع. وفي الأحوال كافة، فإن العنف، ليلتي السبت والأحد، في 18 و19 الجاري، كان أشرس كثيراً منه في ليلة الثلاثاء، كما أن الذين أوقفوا ونُقلوا إلى الزنزانات أكثر كثيراً. هؤلاء حين يخرجون سيقولون لنا ما الذي سمعوه هناك، وهم – في أغلب الظن – سيعززون ما بتنا نعرفه عن «ثقافة» العقاب الأسدية في بيروت.