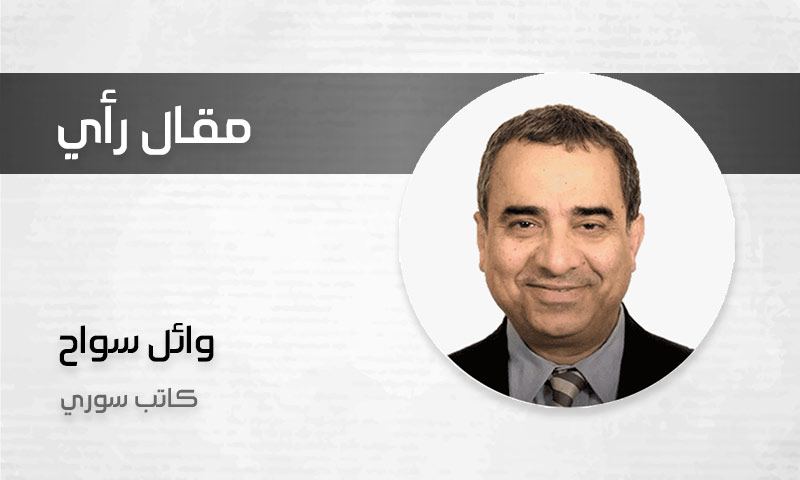حين انقلب حافظ الأسد في سورية على رفاق دربه، وزجّهم في سجن المزّة، حتى تقبّضهم ملك الموت، كان في جعبته جملة من الأفكار، من بينها تخفيف التوتر مع الدول الغربية، وتحسين العلاقات مع محور الاعتدال العربي باسم “التضامن العربي”، وفتح فرجة في القبضة المحكمة للحكومة على الاقتصاد السوري، ما سمح بظهور تدريجي لطبقةٍ جديدةٍ من الأثرياء الذين راحوا يراكمون ثرواتهم عن طريق العقارات والاستيراد والتصدير.
أحد أصهاري في مدينتي حمص، واسمه عبد الكريم، كان واحدا من هؤلاء الذين بدأوا يطفون على ساحة الأعمال. كان متعهّدا بسيطا، فتحت الحكومة أمامه باب المناقصات، فأثرى خلال زمن قصير. وبـ “الثروة”، أعني شقّة واسعة في مطبخ كنّا نسميه أميركيا، لأن فيه خزنا (من الفورميكا) بدل الرفوف الخشبية العارية، وفيه صالون واسع وغرفة سفرة، مع سيارة ورصيد في البنك ببضع مئات الألوف من الليرات السورية.
دعانا عبد الكريم مرّة إلى غداء، واستقبلنا أمام باب بيته بعبارة “أهلا بكم في بيتنا المتواضع”. ثمّ اصطحبت زوجته أمي وأختي في جولةٍ لتعرّفهما على بيتها الجديد، وقد اصطبغت وجنتاها بحمرةٍ فيها مزيج من الخجل والبهجة والخيلاء.
بعد عشر سنوات، حيت سيطغى رفعت الأسد، شقيق حافظ، على مقدّرات البلاد والعباد بواسطة التهريب والاستئثار بكلّ المناقصات الكبيرة، بدأت ثروة عبد الكريم تتآكل، وقد فقد كثيرا من موارده، بسبب هيمنة رفعت الأسد، فباع بيته واستأجر شقّة صغيرة، ثم مات دون الستين من عمره قهرا.
مع عبد الكريم، كانت طبقة جديدة قد ظهرت، ولم تكن تحتاج وقتها لتكون من منطقةٍ معينةٍ أو طائفةٍ معينة لتستفيد من ذلك الانفتاح. ولم يكن شرطا أن تكون لك علاقة شراكة بأحد المتنفذين في حزب البعث أو المخابرات. ولكن النخبة الحاكمة التي انتبهت إلى مزايا السوق راحت تحتكر كل الموارد الممكنة، ثم أخذت تختلف، فيما بينها، إلى أن أوشكت على استخدام الدبابات في مدينة دمشق، لحلّ المنافسة بين رفعت الأسد وبقية الجنرالات. وفي منتصف الثمانينات، وجّهت القيادة السوفياتية دعوة رسميّة إلى رفعت الأسد وشفيق فياض، قائد الفرقة الثالثة، وعلي حيدر، قائد الوحدات الخاصة، ومحمد الخولي، رئيس المخابرات الجوية، لزيارة موسكو. وقد سمحت موسكو لحيدر وفياض والخولي بالعودة، ولكنها القيادة الكريمة أصرّت على إبقاء رفعت في ضيافتها حتى قبل الابتعاد عن سورية، لقاء مبلغ ضخم، لم يكن متوفّرا في الخزينة لحظتذاك. وسيحدّثنا مصطفى طلاس، وزير الدفاع الأسبق، في كتيّب صغير عن أحداث عام 1984، كيف أن المصرف المركزي السوري كان “خاويا حتى من الفئران”، فاستنجد الأسد بصديقه الليبي معمّر القذّافي الذي كان “والحمد لله بمزاج حسن، وتذكّر مواقف الأسد القومية في دعم الثورة الليبية ومؤازرتها، ورد على رسالة الأسد ردا جميلا، وتم تحويل المبلغ بكامله إلى المصرف المركزي”.
كانت الثمانينات مرحلة كالحة من التاريخ السوري، حيث انعدمت السلع من السوق، وازدهرت عصابات التهريب المرتبطة مباشرة بالأجهزة الأمنية والحزبية والحكومية التابعة لحافظ الأسد. واحتكر رجال الأسد النهب، وحاصروا الأعمال التي كانت بدأت أو عادت في السبعينات. وراكم ورثة رفعت الأسد ثرواتهم من التهريب والفساد ونهب قطاع الدولة، ولكن الثروات المتراكمة لم يكن لها منصرف، بل بقيت في معظمها ثرواتٍ نقدية.
مطلع التسعينات، كان الوضع الاقتصادي في سورية قد وصل إلى حافّة الانهيار، وكانت الوزارات لا تملك في خزائنها سوى رواتب موظفيها، بينما توقفت حركة المشاريع في البلد، بما فيها الخدمية الأساسية، والحجّة دائماً عدم وجود موارد مالية لتنفيذها. ومع سقوط جدار برلين، ومن ثم السقوط المدوّي للاتحاد السوفييتي، وانعقاد مؤتمر مدريد، رأى حافظ الأسد أن الوقت قد حان لبعض الانفتاح الذي يمكّن محسوبيه من استثمار ثرواتهم أو غسلها، فأصدر القانون رقم 10 الذي شجّع على “استثمار أموال المواطنين العرب السوريين المقيمين والمغتربين ورعايا الدول العربية، والأجنبية، في المشاريع الاستثمارية، ضمن إطار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العامة للدولة”، مركّزا على قطاعات الزراعة والصناعة والنقل. تحرّك السوق في سورية، وعادت بعض الأموال السورية في الخارج للاستثمار، ولكن معظم أموال الاستثمار جاءت في الحقيقة من “تحت البلاطة” كما يقول السوريون، وهي الأموال التي راكمها المقرّبون من النظام والأجهزة الأمنية في الثمانينات.
وذهل السوريون بالأرقام التي بدأت تقارير صحافية تتداولها من الثروات المتراكمة، فحين قتل باسل الأسد في حادث سيارةٍ مشكوكٍ فيه، كانت ثروته قد بلغت، وفق بعض التقارير، 13 مليار دولار، وهو مبلغ خرافي، إذا ما قيس بموازنة سورية في تلك المرحلة التي لم تكن تتجاوز خمسة مليارات دولار.
على أن ذلك كله يعتبر لعب أطفال بالنسبة لما آلت إليه الأمور بعد وصول بشار الأسد إلى السلطة في عام 2000، وتطاول النفوذ الذي مارسه عليه خاله محمد مخلوف وولده رامي. دفع النظام الجديد نحو ما بدا ظاهريا انفتاحا أكبر للسوق، من خلال تبنّي شعار “اقتصاد السوق الاجتماعي” والخطة الخمسية العاشرة. وبدأ النظام يقدّم سورية رسمياً باعتبارها سوقا ناشئة تمرّ بمرحلة تحرّر اقتصادي، على أمل اجتذاب الاستثمارات الدولية والمساعدات. غير أن واقع الحال أن أسرتي الأسد ومخلوف، ومن والاهما من رجال الأعمال، قد خزّنوا مبالغ كبيرة من المال، من خلال سيطرتهم على الاقتصاد السرّي والسوق السوداء، وباتوا الآن بحاجةٍ إلى بنية تحتية اقتصادية حديثة، تعمل على إعادة توجيه الأموال النقدية التي في حوزتهم واستثمار لبناء أعمال تجارية تندمج في النظام المالي الدولي.
وبينما اشترى رجال أعمال خليجيون ومصريون حكاية الانفتاح السوري، وأخذوا يبنون شراكاتٍ مع متنفّذّين سوريين في مجال العقارات والاتصالات تحديدا، سرعان ما اكتشفوا أن جوهر القضية لم يتغير، وأن سورية ما زالت بلدا يحكمه الولاء الشخصي، وتُسخّر فيه المنظومة القضائية لمصلحة العائلة والدائرة الأكثر قربا إليها، بينما تتولّى الأجهزة الأمنية إزالة المنافسين الذين قد يتحدّون الاحتكارات الحالية، أو يسعون إلى المشاركة في الأرباح. ولا تزال في الذاكرة قصّة نجيب ساويرس الذي شارك رامي مخلوف في بناء شركة سيرياتل للهاتف المحمول، ولكن سرعان ما أقصى مخلوف “أوراسكوم” عن عمليات “سيرياتل” بمجرّد إقلاعها، مستفيدا من سيطرته على النظام القضائي في سورية.
بعد الثورة السورية، بدأت أعداد السوريين المقرّبين من عائلة الأسد الذين تشملهم العقوبات الأميركية والأوروبية والبريطانية والكندية تتّسع، فلجأ النظام إلى إيجاد شبكة من خيالات الظل (خيال المآتة) التي تطرد الطيور من الكروم، للتحايل على العقوبات. واختار هؤلاء الأشخاص من أولئك الذين برزوا في ساحة الأعمال، مستغلّين ظروف الحرب، وحاجة البشر للغذاء والدواء والنقود. وهكذا برزت أسماء جديدة، مثل سامر فوز وحسام قاطرجي ومحمد قطّان وياسر عباس وأشخاص آخرين كثيرين، ما إن تكتشفهم آلية العقوبات الغربية حتى يبحث النظام عن بدائل لهم. وهكذا ظهرت طبقة جديدة من رجال الأعمال، ميزتهم الوحيدة انعدام الأخلاق وفقر القيم. طبقة ظهرت من آلام الناس وبؤسهم وحاجتهم، وهي تفتح اليوم أفواهها بانتظار أموال إعادة الإعمار. وبينما كان صهري عبد الكريم مهندسا مجدّا ورجلا نبيلا، حاول أن يؤسّس شيئا بجهده، فإن سامر فوز وشركاه يؤسّسون أرباحهم الهائلة على حساب شقاء بني بلدهم وجوعهم ومرضهم. وفي النهاية، هم لا يراكمون الثروة لأنفسهم، وإنما لأسيادهم المعاقبين، أما هم فليسوا أكثر من خيال المآتة.