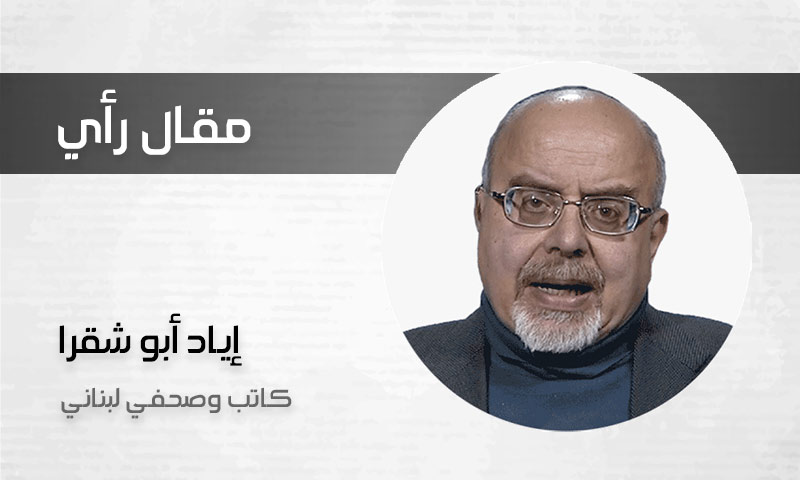كنت أصغي بالأمس إلى محلل سياسي مطلع على الشؤون الإيرانية يتكلم في إحدى الفضائيات العربية. وما لفتني في كلامه رداً على سؤال عن فرص نجاح انتفاضة الشعب قوله ما معناه أنها «قد تنجح بعد 6 أشهر أو 6 سنوات… لكن التململ والمعارضة لن ينتهيا عن طريق القمع».
أعتقد أن هذا كلام منطقي، ولا سيما لمَن يعرف «طبائع الاستبداد» وسلوك المستبدّين، ومَن شاهد كيف تصرّف ويتصرّف «تلامذة» نظام طهران «النجباء» والحلفاء والأتباع، في كل مكان نجحت السلطة الحالية بإيران في «تصدير ثورتها إليه».
يقول عبد الرحمن الكواكبي في كتابه «طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» (صدر عام 1902): «الحكومة المستبدة تكون طبعاً مستبدة في كل فروعها من المستبد الأعظم إلى الشرطي، إلى الفرّاش، إلى كنّاس الشوارع، ولا يكون كل صنف إلا من أسفل أهل طبقته أخلاقاً؛ لأن الأسافل لا يهمهم طبعاً الكرامة وحسن السمعة إنما غاية مسعاهم أن يبرهنوا لمخدومهم بأنهم على شاكلته، وأنصار لدولته…».
زرع ثقافة الموت والتخلف والتعصّب وإلغاء الآخر ظاهرة لن تختفي بسهولة، ولن تقضي عليها إلا ثورة مفاهيم تحتاج إلى وقت غير قصير قبل أن تنضج، وإلى إدراك عميق من المجتمع الدولي لخطورتها عندما يتعامل معها. والحال أن الثورة الخمينية، التي هزّت الشرق الأوسط في عام 1979 ما كانت حدثاً بسيطاً؛ لجملة من الأسباب، أبرزها، ما يلي:
1 – أنها حدثت في إيران، إحدى أهم دول الشرق الأوسط وأكبرها سكاناً ومساحة وأغناها حضارة.
2 – أن إيران دولة نفطية ذات إمكانات اقتصادية ضخمة، وذات قاعدة صناعية وحرفية وعمرانية عريقة.
3 – أن إيران تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي بين العالم العربي وتركيا وشبه القارة الهندية وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق (في القوقاز وآسيا الوسطى).
4 – أن إيران طمحت للعب دور إمبريالي ناشط، منذ القدم، وإبّان «الحرب الباردة» تحوّلت مع كل من تركيا وباكستان إلى «دول احتواء» للتمدّد الشيوعي، وفق التعريفات والاعتبارات الغربية.
5 – أن إيران أكبر بلد إسلامي لا يشكل المسلمون السنّة غالبية سكانه، وهذا واقع تظهر أهميته الاستثنائية اليوم، مع حصر دوائر القرار الغربية حربها المفتوحة ضد «الإرهاب الإسلامي» بـ«الإسلام السياسي السنّي». إنه الواقع الذي أتاح ويتيح للقيادة الإيرانية طرح نفسها شريكاً للغرب في «الحرب على الإرهاب»، وهو ما زال في صميم المنطق الغربي بالتعامل معها.
6 – أن إيران بلد «مؤسساتي» قديم أسهم منذ العصر العباسي، ليس فقط في بناء ثقافة جماعية مهنية وحرفية، بل صارت «نقاباته» منطلقات للتيارات والحركات الفكرية والجدلية في تاريخ الإسلام وتاريخ منطقة الشرق الأوسط. ومن ثم طوّرت عبر العقود مؤسسات مدنية ومذهبية وحركات عسكرية وشبه عسكرية ما زالت مفاعيلها موجودة حتى اليوم، إذا ما نظرنا إلى «أخطبوطية» الحرس الثوري الإيراني ومؤسساته الاستثمارية (المشروعة وغير المشروعة) المتخصّصة في كل المجالات، واستطراداً، إلى التنظيم الدقيق لإفرازات الحرس الثوري في المناطق العربية التي تسيطر عليها ميليشياته التابعة في لبنان والعراق واليمن… مقابل ارتجالية خصومه وفرديتهم وسوء تخطيطهم وتنظيمهم.
كل هذه العوامل أسهمت في إطالة عمر نظام تفنّن منذ 1979 في اضطهاد نخب مثقفيه ومعارضيه، ودفعهم دفعاً إما إلى المنافي أو إلى المشانق والزنزانات.
لقد بدأت معارك الثورة الخمينية الداخلية منذ الأشهر الأولى من نجاحها، وأبعِد أو هُمِّش يوماً بعد يوم بعض كبار رموزها من السياسيين ورجال الدين، من أمثال مهدي بازركان، وأبو الحسن بني صدر، وصادق قطب زادة، وآية الله شريعتمداري، وآية الله طالقاني، ثم آية الله منتظري، ومير حسن موسوي، ومهدي كروبي.
وبالتوازي، تحوّل النظام أكثر فأكثر إلى البنية الأمنية – المالية، وصار الحرس الثوري صلبه ووجهه وعلّة وجوده.
خلال السنوات الأولى من عمر الثورة الخمينية انجذب إليها آلاف المثقفين العرب والأجانب إعجاباً بشعاراتها الثورية المحفِّزة لـ«المستضعفين» و«شجاعتها» في مقارعة الظلم والإمبريالية و«قوى الاستكبار».
شخصيات عديدة ليبرالية ويسارية، في مشارق الأرض ومغاربها، اعتبرت تلك الثورة في يوم من الأيام نموذجاً ناجحاً، مع ترهّل التجربة السوفياتية والتحوّل الماوي نحو البراغماتية. وفي بعض الكلمات التي ألقيت في جلسة مجلس الأمن الدولي بالأمس ما يذكّر ببراءة تلك الحقبة، ولا سيما، من مندوب بوليفيا.
ولكن في المقابل، ما كانت كل المواقف الرافضة اتخاذ أي إجراء فعّال ببراءة الموقف الرسمي البوليفي الذي يمثّل اليسار اللاتيني… الكاره تاريخياً لـ«اليانكي» الأميركي.
في الحقيقة، كانت هناك دوافع أخرى…
لدى روسيا والصين دوافعهما الخاصة في معركتيهما كقوى عالمية صاعدة تناوئ واشنطن وتستغل في كل مناسبة أخطاء حساباتها. ملامح هذه «المعركة» تبدو للمراقب… من مواقف روسيا والصين الصريحة في دعم بشار الأسد في سوريا، إلى دعمها المبطّن ابتزاز كوريا الشمالية النووي لواشنطن وحلفائها الآسيويين.
ثم هناك المواقف الدولية الانتهازية، ولا سيما، من الدول الأوروبية الكبرى التي لديها استثمارات ضخمة في إيران.
هذه الدول حريصة على مستقبل النظام لأنه يشكل ضمانة لاستثماراتها، وبالأخص، أنها في المجال الاستثماري داخل إيران «منافس» للولايات المتحدة وليست حليفاً.
وبعدها، هناك الدول التي تميل إلى التفسير التقليدي لدور مجلس الأمن، من حيث إنه مخوّل للتدخّل في النزاعات بين الدول أو الأزمات الكبرى التي قد تؤدي إلى تدخلات دولية. وعليه؛ فهي لا ترى أن في الاعتراضات الداخلية في دولة ما – إيران في هذه الحالة – ما يبرّر أي دور لمجلس الأمن.
وأخيراً، وليس آخراً، هناك دول لا ترتاح إلى السياسة الأميركية الخارجية، وبخاصة، في عهد إدارة الرئيس الحالي دونالد ترمب التي لا تحظى بتأييد بعض أقرب حلفاء واشنطن التقليديين القدامى.
وبناءً عليه، يمكن الافتراض أن واشنطن عندما قرّرت مواجهة الملالي في مجلس الأمن كانت تدرك سلفاً المزاج الدولي ضدها، ولا سيما، بعد تحديها قرارات المجلس نفسه باعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل…
هذه باختصار «العلاقات الدولية موديل 2018»!