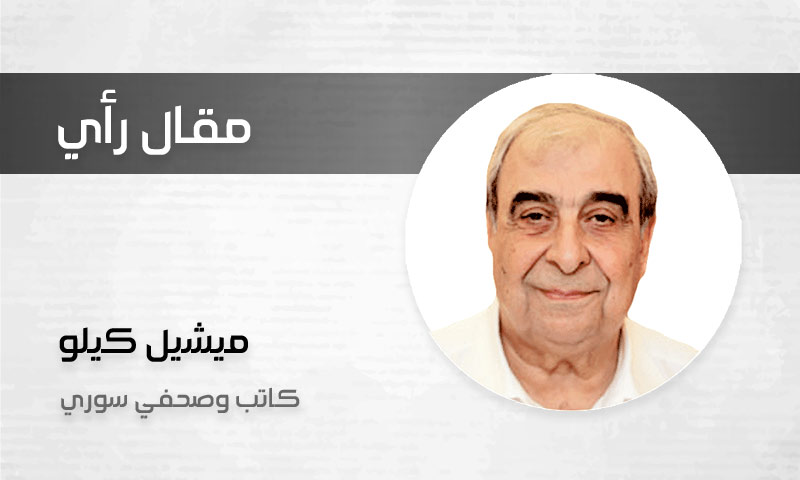بدأ قبل أسابيع عد عكسي دولي، لحل موضوع جبهة النصرة باعتبارها تنظيماً قاعدياً. هذا ما يمكن أن يلاحظه، ويتأكد منه، أي مراقب لما يعد لإدلب.
لن يكون زمن ما بعد جبهة النصرة كالزمن الذي كان قبلها. إنّ تراجعها، وربما تلاشيها، يجب أن يكون لحظة مفصلية في سياسة الشعب السوري وثورته، وهو الشعب الذي تسلطت هي و”داعش” عليه في وقت واحد، وأنزلت بهيمنتها على الساحة خسائر فادحة بالسوريين، منها، على الصعيد السياسي، ثورة الحرية بطابعها المجتمعي العام ونهجها السلمي، وطابعها السياسي القائل بالحرية والمواطنة المتساوية الذي أزاحه العنف المسلح والمعادي للسياسة وحملتها، وأحل محله مذهبية/ دينية، سوغت ما ارتكبه من جرائم على جميع الأصعدة، ضد مجتمع أسهمت في تمزيقه وتحريض مكوناته، بعضها ضد بعض، في سياق تبنّت خلاله نهج الأسدية الرافض للحرية وللاعتراف بوحدة الشعب السوري، والقائم على تسعير الحرب بين طوائف متنافية الأهداف لا تقبل العيش المشترك في دولة ديمقراطية، رفضها الأسد، واعتبرتها جبهة النصرة كافرة، يجب القضاء عليها وعلى القائلين بها.
طوى ظهور “النصرة” و”داعش” معادلة الثورة الأصلية التي جعلت النظام الديمقراطي بديل الأسدية، بدعم من وثيقة جنيف وقرار مجلس الأمن 2118، وما تضمناه من محدّدات أقرها الخمسة الكبار بالإجماع لحقوق الشعب السوري، وأرسى بدلاً منها معادلةً جعلت الإرهاب المذهبي بديل الديمقراطية، وأحدثت تبدلاً انقلابياً في موقف الدول من الثورة والحل السياسي، وأدخلت السوريين في مقتلةٍ دامت قرابة أربعة أعوام، ذهب ضحيتها مئات آلاف السوريات والسوريين. واليوم، وبعد اقتراب الحرب ضد “داعش” في محافظتي الرقة السورية ونينوى العراقية من نهايتها، وحل مشكلة جبهة النصرة في إدلب، تبدأ ثورتهما المضادة بالتلاشي والزوال، وتطرح نفسها من جديد مهمة صعبة، لكنها ممكنة التحقيق، هي استعادة رهانات ثورة الحرية وحراكها المجتمعي السلمي، وتحصينها ضد أخطاء النشأة وعيوبها التي لازمتها إلى اليوم، ومكّنت المتمذهبين الإرهابيين من كسب قطاعات مجتمعية واسعة أيدتها، وانفصلت عن الثورة، اكتسب معظمها خلال سيطرة “داعش”/ جبهة النصرة المريرة والمكلفة، الوعي بحتمية الانفكاك عنهما نهجاً، واستعادة رهانات الثورة الأولى، ونزل من جديد إلى الشارع لإدانتهما والتنصل من ممارساتهما، والتخلص من دورهما في تخريب ثورةٍ صار وجود سورية الدولة والشعب يتوقف اليوم على تجميع قواها وتوحيدها، وإعادتها إلى أهدافها التي قدّمت أعز التضحيات لتحقيقها طوال عام تمرّدها الأول.
يحتم ما سبق قوله الاستناد مجدّداً على الحراك السلمي/ المجتمعي الذي يجب تجميع جداوله وتحويلها نهراً جارفاً، تتجمع مكوناته في كل مكان من سورية، وتهتف لحرية الشعب السوري الواحد، وهي ترفع علم الثورة الأخضر وحده، من دون أي علم أسود أو مذهبي. لا بد من مساندة هذا الجديد الحميد بكل ما هو ضروري على صعيدي الوعي والممارسة، كي يكون حصيناً، وتتقلص قدرة دجالي المذهبية على تضليله، ويقتنع العالم، في المقابل، بأن لدى السوريين رهاناً استعادوه، ولن يحيدوا بعد اليوم عنه، هو الحرية لشعبهم الواحد، غير القابل للقسمة أو التفتيت والتطييف، وأن مئات المجازر، وتدخل الخارج الإرهابي متنوع الجنسيات، لن يثنياهم عن طلب الحرية والتصدّي لمشكلاتهم وحلها، تعزيزاً لقيم العدالة والمساواة، وما يناضلون في سبيله من كرامة إنسانية.
بعد زوال جبهة النصرة وتنظيم داعش، من المحتم أن يُزال أي أثر لهما في فكر السوريين وممارساتهم، ويمحو تراثهم الإجرامي من ذاكرة الشعب الثائر، عبر اعتماد برامج عمل وطني فيها مكان مستحق لجميع مكونات الجماعة الوطنية السورية، تجريم الطائفية، العقبة الكأداء التي كبحت بقوة تماسك حراك الثورة وتماسك الشعب، وفكّت طوق العزلة عن الأسدية، وقلبت ثورة الشعب ضد النظام إلى حرب بين السوريين، بدعم أسدي/ داعشي/ نصراوي، وحالت دون افتضاح ما يكنه الأسد من عداء تجاه جميع فئات الشعب، بما فيها التي ضحى بأجيال منها في سبيل كرسي لا يستحقه، يعلم كل سوري أنه لم يصل إليه بجدارته أو خبرته، وأنه تعامل مع المسؤوليات التي ألقاها منصبه على عاتقه بخفة البلاهة.
ستتقدم قضية الحرية والثورة، بقدر ما تنفصل عن “النصرة” و”داعش”، وتتخلص من الضرر الذي ألحقتاه بالشعب، بواسطة تنظيميهما السفاحين، وما تدفق عليهما من أغراب تشير ممارستهم وأقوالهم التي اعتبرت أعداء الأسد أعداء لهما، وغلبت خلافاتهم التي يمكن حلها بالحوار والقبول المتبادل على تناقض الثورة العدائي مع النظام، وهو التناقض الذي لا يحلّ بغير السلاح، واعتبرت الخلافات تناقضاتٍ عدائية، أزالت طرفها الآخر بالسلاح، في حين حولت التناقض العدائي مع الأسد إلى خلافٍ جاهرت برفض حله قبل إبادة من يقاتلون نظامه من الثوار!. ستنتصر الثورة السورية بقدر ما تمنع ظهور إرهابيين في صفوفها، وتضفي طابعاً مدنياً على مؤسساتها، فيكون القانون للقانونيين، وتكون المحاكم للقضاة، والمواقع المدنية للمحامين والإداريين، والحرب والقيادة للمؤهلين وذوي الخبرة من ضباط الجيش المنشقين… إلخ.
نحن أمام نهاية مرحلة وبداية أخرى، مختلفة جذرياً عنها في منطلقاتها ووسائلها وأهدافها، فإما أن نتعامل معها بهذا المنطلق، ونخرجها من عوالق الفساد والتمذهب ومستحاثاتهما التي شوهتها، فتنتصر، أو أن نسمح لمن دمّروا سورية وشعبها وثورتها باستعادة دورهم الذي سبق لهم أن وضعوه في خدمة الأسدية، بينما أمعنوا في سفك دماء السوريين، ومحاربة حلمهم بالحرية، وبدولة ديمقراطية تكون لهم جميعهم. لقد أنقذ هؤلاء الأسد بالأمس، فهل نسمح لهم بإنقاذه من جديد، أم نقتلعهم من جذورهم فنرتاح ونريح؟.