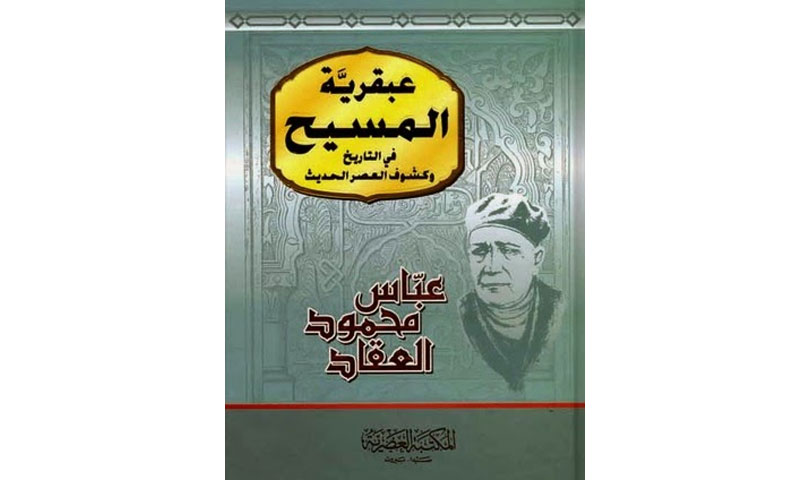لعلّ التنقيب التاريخي الذي كان يدأب عليه المؤرخون على الدوام، وإجراء المقارنات بين الماضي والحاضر، راكم عبر السنين والعصور لدى المؤرخين والمتأملين قناعة مفادها أنّ ملة ومفاهيم النفس الإنسانية واحدة، وأنّها تكرر ذاتها في كل العصور، بأهوائها وأطماعها، وغاياتها ومُتجنّبها، وأساليبها ومكرها، وطباعها السيئة، وخصالها النبيلة، وأن ما يختلف فقط هو أدوات ووسائل تحقيق تلك الجذور البشرية في تلك النفوس.
من هذا المنطلق ولهذا الداعي كتبَ عباس العقاد كتابه “عبقرية المسيح”، وهو الكتاب الحيادي جدًا، والذي يستطيع أن يميز فيه من يقرأه، أنه تناول الحدث دون الانحياز، وقدّم القصة بغير تدخل، بعيدًا عن الغلو والآراء المتضادة.
تطرق الكتاب للناحية الدعوية والروحية والإنسانية لحياة المسيح، كما استعرض المذاهب الفلسفية والروحانية التي كانت تنتظرُ دعوة المسيح على الجانب الآخر، كقطبٍ فكريٍّ موازٍ محمولٍ في قناعات وأذهان الناس.
الكتاب وضّح حجم الضغوطات التي مُورسَت على دعوة المسيح من عدة أقطاب، أولها السلطة السياسية، وثانيها تعدد المذاهب الفلسفية وبقايا شرائع الأديان في أذهان ونفوس الناس، الأمرُ الذي سيصعّب عليه مهمته، والقطبُ الثالث السلطة الدينية المتشددة ممثلةً بالهيكل وسدنته، واحتكارهم للعمل الديني الموصل إلى الله، كما توهّم الناس.
الكاتب، في بعض المواضع، استعرض سياق الحاضر وسياق بني إسرائيل، تاركًا للقارئ بمفرده أن يربط بين المتشابهات، وأن يستخرج ذات الحلول التي ساهمت في إنجاح دعوة المسيح، ليُسقطها على مرحلته وزمنه باستخدام أدوات الحاضر.
لم يُغفل الكاتب ذكرَ “الغائب المنتظر” لدى بني إسرائيل، وأوضح أن صورته كانت تتوزع على نوعين في أذهان وآمال الناس في تلك الفترة، ففي السنوات التي يعيشون فيها الظلم والاستعباد، يغدو المهدي في أنظارهم بطلًا قويًا سيأتي في مقدمة جيشٍ ويخلصهم من الاستبداد، وأما في سنين الرغد والترف، فإن صورته تستحيلُ إلى رجلٍ زاهدٍ سيكونُ على يديه كسرُ أغلال عبوديتهم للمادة والترف.
يطغى على الكتاب اللغة الفلسفية، والنبرة المجردة من الروح، وهذا طبيعيٌّ لكونه كتابًا تاريخيًّا، فيما يشتكي الكثيرُ من القراء من صعوبة ألفاظه وأكاديمية مصطلحاته.